التحوّلات الرمزية والوجدانية في الوعي الإسلامي بعد عاشوراء
النجف الأشرف ـ إکنا: ليست كربلاء مجرّد واقعة تاريخية دامية حُفرت في ذاكرة المسلمين، بل هي لحظة تأسيسية أطلقت شرارة تحوّلات عميقة في بنية الوعي الإسلامي، وفتحت للثقافة بابًا جديدًا تتداخل فيه المأساة مع الإبداع، والدمع مع الفن، والحدث مع الرمز.
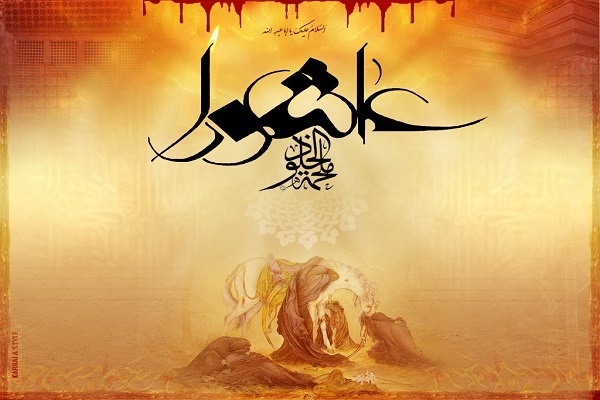
"بسم الله الرحمن الرحيم
ليست كربلاء مجرّد واقعة تاريخية دامية حُفرت في ذاكرة المسلمين، بل هي لحظة تأسيسية أطلقت شرارة تحوّلات عميقة في بنية الوعي الإسلامي، وفتحت للثقافة بابًا جديدًا تتداخل فيه المأساة مع الإبداع، والدمع مع الفن، والحدث مع الرمز.
لقد أنجبت كربلاء المقدسة ثقافة حيّة، لا تزال تتجدّد في الشعائر، وتتجدّد في اللسان، وتتكرّر في الوجدان، وكأن الحسين عليه السلام لم يُقتل في سنة 61 للهجرة، بل يُولد كل عام في صوت شاعر، أو دمعة طفل، أو راية سوداء ترتفع على باب بيت صغير في قرية نائية.
أولاً: الحزن كهوية ثقافية لا كحالة شعورية
مع كربلاء، لم يعد الحزن طارئًا على الروح، بل صار جوهرًا من هويتها. في محرم الحرام وصفر، يتشح الوجدان بالسواد، لا بمعناه اللوني، بل بوصفه رمزًا للصراخ الصامت، وثوبًا من الولاء الصامت. إنه حزن لا يشيخ، لأنه متجدد بالحقيقة، لا بالتقليد.
لبس السواد لم يكن تقليدًا موروثًا فحسب، بل تعبيرًا عن انتماء وجودي لقضية تستحق أن يُحدّ عليها إلى الأبد.
إقرأ أيضاً:
ومواسم الحزن، من العاشر إلى الأربعين، أصبحت طقوسًا روحية تؤسس لما يمكن تسميته بـ"الزمن الحسيني"، تتبدّل فيه الأولويات، وتتقدس فيه الذكرى، وتعود القيم إلى مسرح الوعي.
إقرأ أيضاً:
ومواسم الحزن، من العاشر إلى الأربعين، أصبحت طقوسًا روحية تؤسس لما يمكن تسميته بـ"الزمن الحسيني"، تتبدّل فيه الأولويات، وتتقدس فيه الذكرى، وتعود القيم إلى مسرح الوعي.
ثانيًا: الأدب الحسيني… إعادة تشكيل اللسان والخيال
بعد كربلاء، تغيّر وجه الشعر العربي؛ فلم يعد الشعر زينة الملوك، ولا تمجيد الفاتحين، بل أصبح صوت المظلومين، ورسول الحزن، وراوي الجراح.
نشأت مدرسة شعرية حسينية، تُبكي ولا تُطرِب، تُلهب ولا تُزخرف، تعزف على أوتار القلب وتستدعي أقدس ما في الإنسان: ضميره.
وفي ثنايا القصائد، خُلقت لغة جديدة، مفرداتها: "الطف، العطش، المظلوم، السبط، السيدة، الرأس، السبي..."
مفردات لا تشرح الحدث، بل تُعيد خلقه.
أما أدب المقتل، فهو ملحمة لغوية تحوّلت إلى طقس يُتلى، وجسر بين الحدث والوجدان.
ففي رواية مقتل الرضيع، أو صهيل فرس الحسين , مصيبة علي الأكبر، أو فجيعة زينب، نسمع الدم وهو ينطق، لا القلم.
ثالثًا: المجلس الحسيني... منبر ثقافي جامع
المجلس الحسيني ليس مجرد نادٍ للبكاء، بل هو ملتقى جماعي تعاد فيه صياغة الوعي الشعبي والديني والأخلاقي.
فيه تُروى الحكاية من جديد، لكن لا كخبر، بل كقضية.
فيه يتعلّم الصغير أن يبكي لله، والكبير أن يحزن للحق، والعاقل أن يُعيد التفكير في معنى العدل والظلم.
إنها تجربة معرفية وجدانية، تندمج فيها الخطابة بالشعر، والرثاء بالتاريخ، والتأمل بالانفعال، فتنمو من خلاله شخصية المؤمن، لا على الورق، بل في الحياة.
رابعًا: الطقوس الشعبية... ذاكرة تمشي على الأرض
اللطميات، المواكب، التشابيه، زيارة الأربعين... ليست مظاهر خارجية، بل طقوس تعبيرية تؤسس لذاكرة جمعية، وتحفظ القضية من الموت بالنسيان.
اللطميات تحوّلت إلى "نشيد جماعي" يُردّد الجرح، ويعيد خلق الشعور المشترك.
رفع الرايات فوق البيوت صار إعلان ولاء صامتًا، لكنه أبلغ من كل بيان.
المشي إلى كربلاء تحوّل إلى سفر داخلي في الذات، رحلة من الترف إلى التقوى، من الروتين إلى التقديس، من الظل إلى النور.
خامسًا: تشكّل لغة وجدانية خاصة
بعد كربلاء، ولدت لغة جديدة في اللاوعي الجمعي:
لغة لا تُقرأ في القواميس، بل تُستنبط من المجالس، والمواكب، والدموع، والصمت حين تذكر عاشوراء.
في هذه اللغة، تُصبح المفردة شحنة عاطفية لا تُقال، بل تُستَشعَر.
وفيها يصبح الحديث عن "الرضيع" كافيًا لاستحضار عالم كامل من الوجع، والإيمان، واليقين.
أخيراً نقول:
لقد تحول الحسين(ع)... من دم إلى ثقافة، ومن مأساة إلى ذاكرة خالدة .
لقد خرج الحسين عليه السلام ليُعيد للحق روحه، لكنه أيضًا أعاد للثقافة الإسلامية قداستها.
جعل من الشعر صلاة، ومن البكاء قضية، ومن الحزن هوية، ومن الذكرى طقسًا لا يموت.
إن ثورته لم تُنهِ حكمًا فقط، بل أنشأت وجدانًا جديدًا، حُفرت فيه الكلمات بالسيوف، وتشكّلت الحروف من أنفاس الثكالى ودموع اليتامى.
كربلاء، إذًا، ليست ذكرى في كتاب، بل لغة حيّة، لا تتكلمها الشفاه، بل الأرواح.
بقلم الأستاذ في الحوزة العلمية آية الله السيد فاضل الموسوي الجابري
أخبار ذات صلة

