شيعة الكوفة بين النصرة والخذلان: قراءة في ضمير مدينة أنهكها القمع
النجف الأشرف ـ إکنا: ليست كربلاء مجرد واقعة دامية في تاريخ الإسلام، بل هي مرآة صافية عكست اضطرابات الضمير الجمعي في لحظةٍ فاصلة بين الحق المصلوب وسيف السلطان.
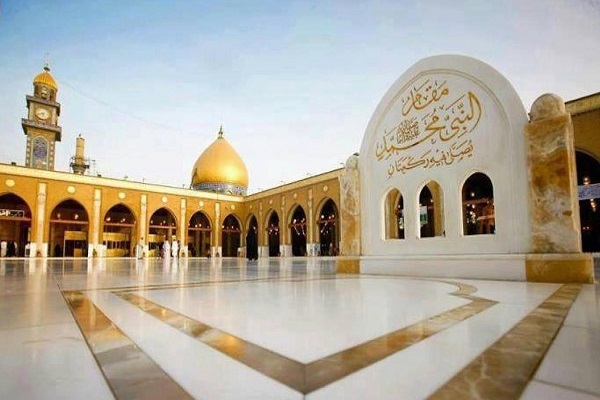
"بسم الله الرحمن الرحيم
ليست كربلاء المقدسة مجرد واقعة دامية في تاريخ الإسلام، بل هي مرآة صافية عكست اضطرابات الضمير الجمعي في لحظةٍ فاصلة بين الحق المصلوب وسيف السلطان. وإذا كانت أبعاد هذه الفاجعة قد طغت على كل تفصيل، فإن موقف شيعة الكوفة يظل من أكثر المواقف التباسًا في الذاكرة التاريخية؛ فهم الذين كتبوا إلى الإمام الحسين(ع) آلاف الرسائل، ثم خذلوه، أو هكذا شاع في الخطاب التاريخي دون فحص منصف للوقائع، ودون استنطاق حقيقي لما جرى في الأزقة الخائفة من مدينة أُنهكت بالقمع، وسُجن فيها الوفاء.
إن القراءة المتأنية لمسار الأحداث تكشف أن الكوفة لم تكن جماعةً متجانسة ولا كتلةً واحدة، بل كانت مدينة تمور بالتيارات المتعارضة والانقسامات الاجتماعية والسياسية: شيعة صادقون، وأمويون متعصبون، وانتهازيون متلونون، وزعامات قبلية متباينة الاتجاه، فضلاً عن جمهور عريض لا ناقة له ولا جمل في صراع السلطة.
كان شيعة الكوفة يشكّلون قاعدة عقائدية عريضة، لكنهم كانوا في الوقت نفسه مخترقين وممزقين، قد أنهكتهم الجراح منذ استشهاد أمير المؤمنين عليه السلام، وتعرضوا بعد ذلك لسنوات طويلة من التنكيل في عهد معاوية، حتى جاء عبيد الله بن زياد، فأكمل الطوق الحديدي، وزرع الرعب في كل ركن، وأطبق على المدينة بسياج من القهر، حتى خنق أنفاس المنادين بالحق.
إقرأ أيضاً:
لقد مارس ابن زياد سياسة ممنهجة لتحطيم الكيان الشيعي الناهض في الكوفة، فبدأ بحملة اعتقالات تعسفية، ونفى الزعماء، وسفك الدماء، وأشاع الخوف في كل بيت. كان مجرد الحديث عن الامام الحسين(ع) يُعد جريمةً موجبة للقتل، حتى إن أحدهم ليرى قريبه مصلوبًا على باب قصر الإمارة، فلا يجرؤ على النطق، لا جبنًا بالضرورة، ولكن لأن الرعب كان قد سلب الألسنة. امتلأت السجون بآلاف الرجال من المخلصين، أولئك الذين كان يُفترض أن يشكلوا العمق الشعبي والعسكري لنصرة الحسين، فغُيّبوا خلف القضبان أو طوردوا حتى لم يبقَ لهم مأوى ولا ملاذ.
أمام هذا الواقع المرير، وجد غالبية شيعة الكوفة أنفسهم في مواجهة قاسية مع ضمائرهم؛ لا يملكون قوةً للنصرة، ولا يطيقون حمل السلاح، فانكمش أكثرهم على أنفسهم، وآثروا العزلة والانزواء، خشية البطش والإبادة. ومع ذلك، بقيت قلة قليلة من الأوفياء، استطاعت أن تتحدى جدار القمع، وتشقّ طريقها إلى كربلاء، حيث وقفت بين يدي الحسين شامخةً كزهير بن القين، وحبيب بن مظاهر، ومسلم بن عوسجة، وغيرهم من الذين جسّدوا المروءة في أنبل صورها.
ولا يمكن فهم المشهد بمعزل عن البنية القبلية المعقدة التي كانت تحكم الكوفة، حيث كانت الزعامات العشائرية تفرض توجهاتها على عامة الناس. وقد كان عدد من شيوخ العشائر ممالئين للأمويين، أو خاضعين لضغوطهم، فكان الولاء للعشيرة يطغى على الموقف العقائدي، ويُسحب الناس قسرًا إلى مواقف لم يختاروها بقلوبهم، بل فُرضت عليهم بقوة التقاليد وسطوة الزعماء.
ثم جاءت لحظة الحسين… لحظة الحقيقة التي ميّزت كربلاء بها القلوب لا السيوف، واختُبر فيها الإنسان في جوهره العميق: أن يقف مع الحق ولو وحيدًا، أو يتوارى في ظلال الباطل خوفًا أو ترددًا. لقد كان الجيش الأموي الذي قاتل الإمام عليه السلام خليطًا من المرتزقة، والمغرر بهم، وأبناء العصبيات الجاهلية، ولم يكن يمثل كل الكوفيين. بل كانت الأغلبية الساحقة من الكوفيين آنذاك مقموعة ومقيدة، لا تملك لا كلمةً ولا سلاحًا.
والمؤلم أن من بين أولئك الذين كتبوا للإمام ثم خذلوه، لم يكن كلهم خائنين بطبعهم، بل كثير منهم وقع ضحية الخوف والترهيب، وفوضى الوعي التي تضرب الجماهير في لحظات الأزمات. ومع ذلك، فإن هذا لا يعفيهم من مسؤولية التخلي، ولا يبرر لهم التراجع، لأن دروس كربلاء كانت ولا تزال تصرخ: أن الصمت في وجه الظلم هو خذلان، ولو تذرّع بالخوف.
لقد دفعت الكوفة الثمن غاليًا بعد ذلك. فعقب المأساة، استفاق الضمير الكوفي على صدمة الذنب، وهبّت موجات الندم تجتاح القلوب، فانطلقت حركات الثورة تباعًا: بدءًا من انتفاضة التوابين، ثم ثورة المختار، وسلسلة من المحاولات الأخرى، كلها جاءت تحمل شعار التكفير عن موقف أسود، ترك جرحًا غائرًا في قلب التاريخ.
وإذا كان بعض المؤرخين قد سارعوا لتسجيل خذلان شيعة الكوفة في كتبهم، فإن التحقيق المنصف يثبت أن من قاتل الإمام الحسين عليه السلام لم يكن عامة الشيعة، بل كانت الطغمة الحاكمة ومن يدور في فلكها من المرتزقة والمنتفعين وأهل القصور، الذين قالت لهم السيدة زينب سلام الله عليها في الكوفة ووصفتهم : بأنهم أهل الخيانة والنفاق، لا أهل الإيمان والولاء.
كربلاء لم تكن محكمةً تُدِين فيها مدينة بأكملها، بل كانت امتحانًا عسيرًا للإنسان في أشد مفترقات المصير: أن يكون حرًّا ولو في القيود، أو أن يكون عبدًا للذل وهو في القصور.
أما الدرس الذي ينبغي أن يبقى في الذاكرة، فهو أن الخذلان
لا يولد فجأة، بل يُصنع على مدى سنوات طويلة من التراكم: بالخوف المزمن، وتكميم الأفواه، وتضييع الهوية، وفساد القيادة، واختلال الوعي. فشيعة الكوفة لم يكونوا خونة، بل كانوا محاصرين. والخيانة الحقيقية لم تكن من عامة الناس، بل من النخبة المتسلطة التي قال عنها سيد الشهداء: «ويحكم يا شيعة آل أبي سفيان! إن لم يكن لكم دين، وكنتم لا تخافون المعاد، فكونوا أحرارًا في دنياكم هذه، وارجعوا إلى أحسابكم إن كنتم عربًا كما تزعمون!»
وهكذا، تبقى كربلاء، إلى يومنا هذا، ليست فقط معركةً بين جيشين، بل صراعًا دائمًا بين الضمير الحي والضمير الميت، بين وفاء الفرد وخذلان الجماعة، بين صوت الإنسان الحر، وصمت العبودية.
بقلم الأستاذ في الحوزة العلمية بالنجف الأشرف آية الله السيد فاضل الموسوي الجابري
أخبار ذات صلة

