جواهر عَلَويَّة...
مَنْ صَدَّقَ الْواشِيَ أَفْسَدَ الصَّديقَ
إکنا: العلاقات الإنسانية لا سيما تلك القائمة على مبدأ الأخوَّة والصداقة ليست مجرد إلفة بين شخصين، أو توافق بين مزاجين، بل هي عقد بين قلبين قوامه الثقة والاطمئنان، ودائرة يجب أن تصان من الاختراق، فإذا دخلها الواشي والنَّمام نفث فيها سمومه القاتلة، وأحال القلبين مشحونين بالبغضاء والأضغان.
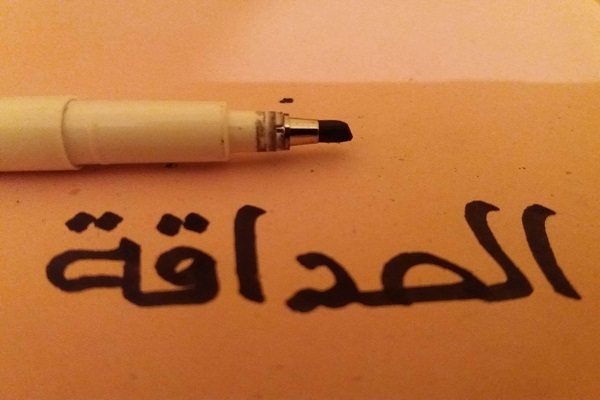
ورُوِيَ عن الإمام علِيَّ (ع) أنه قال: "مَنْ صَدَّقَ الْواشِيَ أَفْسَدَ الصَّديقَ".
العلاقات الإنسانية لا سيما تلك القائمة على مبدأ الأخوَّة والصداقة ليست مجرد إلفة بين شخصين، أو توافق بين مزاجين، بل هي عقد بين قلبين قوامه الثقة والاطمئنان، ودائرة يجب أن تصان من الاختراق، فإذا دخلها الواشي والنَّمام نفث فيها سمومه القاتلة، وأحال القلبين مشحونين بالبغضاء والأضغان.
إقرأ أيضاً:
المعادلة التي يضعها الإمام (ع) لا تنهى عن الوشاية وحسب، ولا تعتبرها فعلاً قبيحاً فقط، ولا تجعل وزرها على الواشي وحده، بل يتحمَّل الوزر أيضاً ذاك الذي يُصدِّق الواشي، ويقبل كلامه، فالوشاية في ذاتها تبقى كلمات تطوف في الهواء، لا أثر لها ما لم تجد أذناً تصغي وقلباً يصدِّق، ففساد العلاقة بين الصديقين لا يأتي بالضرورة من الخارج، بل من الصديقين أو من أحدهما عندما يُلقي بسمعه إلى الواشي المُفسِد، دون تمحيص، ودون تبَيُّنٍ.
ولمّا كانت الوشاية تتمثَّل في نقل كلام الغير بقصد الإضرار به أو الإفساد بينه وبين الآخرين، وهذا ما يستقبحه العقل وينهى عنه، فقد اتخذ الإسلام موقفاً صارماً منها، وشَنَّ حملة قاطعة قاصمة عليها، فأعلن حُرمتها، ونهى عن تصديق الواشي وإطاعته، قال تعالى: وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ ﴿10﴾ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ ﴿11﴾ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴿القلم:12﴾.
إن هذا النهي الشديد، وبهذا التهديد القاصم لتأكيد على خطورة الوشاية وسواها من الرذائل التي ذكرتها الآيات الكريمات، حيث تنهى عن إطاعة الحلّاف، وهو كثير الحلف، ولا يكثر الحلف إلا إنسان غير صادق، يدرك أن الناس يكذبونه ولا يثقون به، فيحلف ويكثر من الحلف ليداري كذبه، وهو مَهين لا يحترم نفسه، ولا يحترم الناس قوله، وآية مهانته حاجته إلى الحلف، وهو همّاز، يهمز الناس ويعيبهم بالقول والإشارة في حضورهم أو في غيبتهم سواء، وهو مَشّاء بنميم، يمشي بين الناس بما يُفسِد قلوبهم، ويقطع صلاتهم، ويذهب بموداتهم، وهو خُلُقٌ ذميم مَهين، لا يتصف به إنسان يحترم نفسه، أو يرجو لها احتراما عند الآخرين، فحتى أولئك الذين يفتحون آذانهم للنمام، ناقل الكلام، المَشَّاء بالسُّوء بين الأَوِدّاء، حتى هؤلاء لا يحترمونه في قرارة نفوسهم ولا يودونه.
إن الوشاية لتُفسِدُ العلاقات بين الأفراد والأُسَر والمجتمعات، وتنشر بين الناس العداوة والبغضاء، وتمزِّق النسيج الاجتماعي، وتوهِنُ روابطه، وتؤذي الناس في أعراضهم وسمعتهم بغير حق.
وعادة ما يستفيد الواشي من ثلاثة عناصر: أولها: حبُّ الفضول، ويتمثَّل في رغبة السامع في معرفة ما يُقالُ عنه أو عن غيره، الثاني: نزعة الشك: وتتمثَّل في الميل الطبيعي لدى الإنسان إلى الحذر من الخيانة والغدر، الثالث: ضعف الثقة بالنفس أو بالآخر، فإذا لم تكن الثقة يقينية يزيلها أي همس في الأذُن، وبمجرد أن يصدّق الإنسان ما يُنقَل إليه دون تحقق، يبدأ ذهنه في إعادة بناء صورته عن صديقه على أسس مشوّهة، فتنشأ مسافة بين القلبين، يفسد بها الصديق قبل أن ينطق أي منهما بكلمة.
نستنتج مما سبق: أن المجتمع لا يفسده الكاذبون وحدهم، بل يساهم في إفساده الذين يصدِّقون الوشاية، ولذلك نجد أن المجتمعات التي تستشري فيها الشائعات، هي في حقيقتها مجتمعات لم تُدرَّب على التثبّت والتحقُّق، بينما المجتمع الذي يتعامل أفراده مع الكلمة كما يتعامل المريض مع الدواء، لا يبتلع شيئاً إلا بعد التثَبُّتِ من سلامته، هو مجتمع عصيّ على التفكك.
بقلم الباحث اللبناني في الشؤون الدينية السيد بلال وهبي
أخبار ذات صلة

