آفة القدرة من منظور الإمام علي(ع)
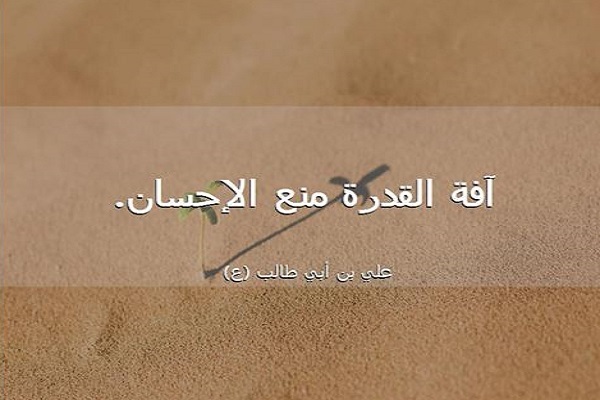
ورُوِيَ عن الإمام علِيَّ (ع) أنه قال: "آفَةُ الْقُدْرَةِ مَنْعُ الإِحْسانِ".
أن تكون عاجزاً عن الاحسان، فلا مَلامة عليك، أَمّا أن تكون قادراً عليه ثم تمنعه عن مستحقيه فأنت مَلومٌ أخلاقياً على الأقل، فإن انحصر الأمر بك مع قدرتك عليه فأنت مَلوم شرعاً، إذ تكون مُقصِّراً في أداء تكليفك العَيني تجاه من احتاج إليك، وقد جاء عن الإمامُ عليٍّ (ع): "أحَقُّ النّاسِ بالإحْسانِ مَن أحْسَنَ اللَّهُ إلَيهِ، وبَسَطَ بالقُدْرَةِ يَدَيهِ".
الإِحْسانُ: معاملة الإنسان غيره بالحُسنى في القول أو العمل، وبَذْلُ كلِّ ما هو حَسَنٌ، سواء كان قولاً أو عملاً أو قصداً، وهو قسمان:
الأَوّل: الإحسان إلى النفس، ويتمثل بترويضها وتهذيب فضائلها، ووضعها الموضع اللائق بها، وحَملها على فِعل الخيرات، والإكثار من الباقيات الصالحات.
ومنه الإحسان في العبادة لأنها حاجة ضرورية لها، فبذكر الله تطمئن، وبالاتصال بالله تسكن وترتاح، ويقتضي ذلك أن يعبد الله بإتقان وإخلاص في السِّرِّ والعَلَنِ، فيأتي بها بخشوع وتذلل ورهبة وخشية، يؤديها على أكمل وجه، وأن يحرص على إتيان الواجبات كلها، ويزيد على ذلك بالإتيان بالمستحبّات، وترك المحَرَّمات، ويزيد على ذلك باجتناب المكروهات ما أمكن.
وقال العلماء: إن للإحسان إلى النفس في العِبادة مرتبتان:
المَرتبة الأولى: أن يعبد الله كأنه يراه، مستحضراً قربَه من الله، عارفاً بمقامه وجلاله وكماله وعظمته، وأنه بين يديه تعالى، وهذه عبادة العارفين.
والمرتبة الثانية: أن يعبد الله مستحضراً رؤية الله له، عالماً بأن الله يراه ويسمعه ويعلم حاله، ويعلم ما في صدره، مطلع على ظاهره وباطنه، وهذه عبادة الرَّهبة من الله والوَجَلِ منه.
الثَّاني: الإحسان إلى الناس، وأَوْلاهم به الوالدان، والأولاد، والزوجة، والأرحام، والجيران، ثم بقية الناس، ولا يقتصر الإحسان عليهم بل تتسع دائرته ليطال البهائم والحيوانات التي جعل الله لها حقوقاً على الإنسان باعتبارها مُسَخَّرة له، ومعنى الإحسان لهؤلاء جميعا أن يؤدِّيَ إليهم حقوقهم، ويجتنب الإساءة إليهم، ويعاملهم بالحُسنى.
وهو قسمان: إحسان واجب، ومستحب.
وقد بين لنا الله تعالى في كتابه الكريم كيف يكون الإحسان إلى الوالدين فقال: "وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿23﴾ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا" ﴿24/ الإسراء﴾.
ودعانا إلى الإحسان سواء كان لأنفسنا أو لغيرنا، وأخبرنا أنه يحبنا حين نُحْسِنُ فقال: "...وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ"﴿195/ البقرة﴾.
وأخبرنا أن مَردود إحساننا يرجع إلينا، فقال: "إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا"﴿7/ الإسراء﴾.
وقد مَدحَت الرِّوايات الشريفة الإحسان وكشفت عن أنه غريزة الأخيار، وأنه غُنْمٌ وذُخرٌ، وأن الكريم من حازه، وأنه أفضل زراعة، وأربح بضاعة، وأنه رأس الإيمان، وأنه سبب لغُفران الذنوب، وأَنَّه يرتقي بصاحبه إلى ذُرى المَجد، وأنه يَجلِب المَحبَّة للمُحسِنْ، وأن "مَن كَثُرَ إحْسانُهُ كَثُرَ خَدَمُهُ وأعْوانُهُ" وكما قال رسول الله (ص): "جُبِلَتِ القُلوبُ على حُبِّ مَنْ أحسَنَ إلَيها، وبُغْضِ مَنْ أَساءَ إلَيها".
ولم يكتفِ الإسلام بدعوتنا إلى الإحسان لمن أحسَنَ إلينا، فذلك واجِبٌ عقلي لا مندوحة للفرار منه، بل يذهب إلى أبعد من ذلك، إنه يدعونا إلى الإحسان لِمَن أساء إلينا، فهذا رسول الله (ص) يقول: "أحْسِنْ إلى مَن أساءَ إلَيكَ" والهدف من ذلك إصلاح حال المسيء، فقد رُوِيَ عن الإمام علِيٍّ (ع) أنه قال: "الإحْسانُ إلى المُسِيْءِ يَسْتَصْلِحُ العَدُوَّ".
بقلم الكاتب والباحث اللبناني في الدراسات القرآنية السيد بلال وهبي

